كم تبعد أور عن مركز مدينة الناصرية الواقعة في جنوب العراق؟ أور التي زارها قداسة البابا حاجَّاً في شهر آذار من العام الماضي، وجعل العراقيون من تلك الزيارة يوماً للتسامح، وها هي ذكراه الأولى تطل علينا هذه الأيام. سؤال قد لا يعني شيئاً بالنسبة لكثيرين، فضلاً عن أن معرفة الجواب تبدو أمراً سهلاً للغاية. فبإمكان أي واحد منا أن يجد الإجابة في بضع ثوانٍ فقط. ولن يكلفه ذلك سوى الرجوع لخرائط غوغل، بوساطة هواتفنا الذكية التي لا تفارق أيدينا ليل نهار. لكن يبدو أن الأمور لا تمضي بالاتجاه الصحيح دائماً، وأنّ من يعتمدون الخطوات العلمية الكفيلة بالوصول للمعلومة الصحيحة أصبحوا نادرين حقاً، وليس أكثر ندرة منهم سوى أولئك الذين يوفرونها لنا بموثوقية وتثبُّت. إننا في الحقيقة نعوم من غير أن نعلم في بحر من أخطاء ليس لها نهاية.
لا تتحدث هذه السطور عن أور، المدينة التاريخية التي عرفت بزقورتها الشهيرة، وكانت أكبر عاصمة في العالم القديم، أيام ملكها العظيم أور نمو مؤسس سلالة أور الثالثة (2112 – 2004 ق.م)، ولا ترغب بتكرار تفاصيل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، برغم من أنها مثَّلت حدثاً تاريخياً بامتياز، وقد سبق لي أن كتبت مقالاً عن ذلك. ولأضف أيضاً أن ما يهدف له المقال هو أبعد من تحديد مسافة بين مدينة وأخرى. في الواقع، إن جوهر ما أريد قوله -مستفيداً من روح المناسبة- له صلة بنا جميعاً، بسبلنا المستعجلة في تحصيل المعلومة، بتعصبنا لها، والوثوق بها أياً كان مصدرها، بأخطائنا التي نجهلها تماماً، وبغرورنا المعرفي الذي يطيب له أن يدعي امتلاك بيانات وخبرات لا وجود لها، بل لا نفكر في أن نبذل جهداً لتحصيلها. وإليكم الحكاية الغريبة التي عشت تفاصيلها، وقررت الكتابة عنها قبل عام، ثم تركت الأمر لأسباب سأذكر بعضها لاحقاً.
المصادفة
كنت أتابع باهتمام تفاصيل اليوم الثاني لزيارة الحبر الأعظم، متنقّلاً بين الفضائيات العربية والأجنبية، مثلما هو حال غيري من العراقيين. لحظتها كان العراق يتصدر أخبار العالم، واسم المدينة القديمة التي تأسست قبل أكثر من أربعة آلاف وخمس مئة سنة لتصبح مهد الحضارة الإنسانية يتردد على كل الألسنة. فها هو البابا فرنسيس برغم كبر سنه قد أتى حاجَّاً إلى مدينة النبي ابراهيم، مع ما يشهده العالم من تمدد مرعب لوباء كورونا، وما يواجه العراق من تحديات أمنية. وجدت في أثناء متابعتي لإحدى الفضائيات الغربية التي تبثُّ برامجها باللغة العربية صحفية عربية معروفة تسهم بالتعليق على الزيارة. ذكرت تلك الصحفية في معرض حديثها أن أور تبعد عن الناصرية بمسافة بضعة كيلومترات فقط. هكذا، من غير تحديد أي رقم. ولا مشكلة في ذلك، إذ لم تكن المسافة تهمني بشيء. بدت لي مجرد تفصيل غير مؤثر عن المدينة التي أعرف عنها أشياء كثيرة، بحكم ولعي القديم بتاريخ العراق. انتقل لمتابعة قناة فضائية عربية تقدم برنامجاً حوارياً عن الحدث، وفيه ذكر أحد الضيوف أن المسافة بين المدينتين هي 40 كم. لا مشكلة حتى الآن أيضاً. لكن في تلك اللحظة بالضبط، صادف أن قمت بتحريك جهاز التحكم بسرعة، لينقلني لفضائية محلية لم أكن لأتابعها، لولا تغطيتها المباشرة لتفاصيل الزيارة، وإذا بإعلامي عراقي يجعل المسافة بين أور والناصرية 20 كم. حسناً. هنا علينا أن نتريث قليلاً. فحين يكون الخلاف في تحديد رقم ما هو الضعف فذلك يعني أننا أمام خطأ كبير. من هنا ولدت الخطوة الأولى لكتابة هذه السطور، وبالنسبة لي، لا أجمل من أن تلهمك المصادفة موضوعاً للكتابة، أنْ تمنحك فجأة فكرة طريفة ومثيرة للشغف، وكأنّ إحدى ربِّأت الجمال والإلهام التسع تهمس في إذنك بسرّ لن يكون في مقدورك أن تكتمه. لقد لعبت الصدفة أدواراً حاسمة في حركة التاريخ، فقررت مصير شعوب وأباطرة وممالك، فما بالنا بمقال بسيط.
بين الرقمي والورقي: أين الحقيقة؟
لم أكن أتخيل ما سألاقيه من عجائب لاحقاً. بدأ الأمر وأنا لا أزال أتابع كلمة قداسة البابا، حين لجأتُ عبر هاتفي المحمول إلى محرك البحث غوغل. كانت موسوعة ويكيبيديا تحتل صدارة النتائج كالعادة. وقد وجدتها تذكر – سأنقل الكلام بنصه - في مادة أور أنها (تقع حالياً على بعد بضعة كيلومترات عن مدينة الناصرية)، أي مثلما ذكرت الصحفية العربية. لكن محتويات أخرى كثيرة تمثلت بمقالات وتقارير صحفية مبثوثة في عالم الإنترنت ستقول لنا أيضاً أن أور تقع على بعد 40 كم إلى الغرب من مدينة الناصرية. وهنا نجد اتفاقاً مع ما ذهب إليه ضيف الفضائية العربية. وماذا بعد؟ المفارقة تتمثل في إني وجدت مواد أخرى يصعب حصرها تذكر أرقاماً مختلفة إلى حدود تدعو للعجب. منها -على سبيل المثال- مقال يتحدث عن 30 كم، ويجعل أور شرق الناصرية لا غربها، وثان يقول إنها 20 كم، وثالث يذكر 19 كم، ورابع يدعى إنها 18 كم، وخامس يقول إنها 17 كم. وحدث أن عثرت على بحث يقرر أن المسافة هي 15 كم فقط. لنلاحظ هنا أن الرقم قد أخذ بالتراجع، وأن الفرق بين الأرقام الأخيرة ليس كبيراً. فهل يعني ذلك أننا قد اقتربنا من معرفة الحقيقة؟ لا شيء مؤكد بالمرة. ومن يقول إن لعجائب ما يُنشر نهاية ما فعليه أن يفكر ملياً. فها هي المسافة تعود لتتراجع إلى 11 كم، ثم إلى 8 كم فحسب!
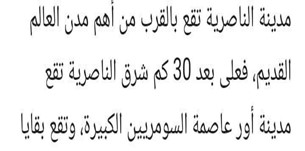
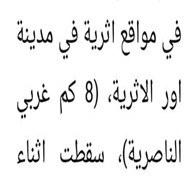
[الصورتان لمنشورين في مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت].
لقد شعرت في البدء بعجب كبير من فارق بلغ الضعف، وها هي الأرقام تتوالى والفارق يزداد وكأننا في متاهة. قلت في نفسي سأحسم هذه اللعبة التي طالت بلا مبرر بالرجوع لمن يؤخذ عنهم من أهل الاختصاص والخبرة. وحين تناولت من مكتبتي مصدراً من تأليف أحد أساتذة علم الآثار المشهورين في العراق، وجدت المسافة فيه 10 كم فحسب. وبرغم الفارق الكبير بين ما بدأنا به (40 كم)، وما انتهينا إليه (8 كم) وجدت نفسي تميل لتبني رأي مؤلف الكتاب، لا لأن الكتب المطبوعة ورقياً أكثر موثوقية مما ينشر في فضاء الإنترنت كما يتصور الكثيرون، فالخطأ هو الخطأ أينما ورد، بل لأننا أمام رأي لأكاديمي يحمل شهادة الدكتوراه، ودرجة الأستاذية (بروفيسور)، وله خبرة طويلة في العمل الأكاديمي وميدان البحث والتأليف، كما سبق له أن أدار مؤسسة كبيرة مهتمة بالآثار. إذن، فلأرجع لمتابعة تفاصيل الزيارة الاستثنائية على الفور. لكن مرة ثانية، ستقودني المصادفة لأقلب صفحات مصدر غربي، يرد فيه أن أور تبعد عن المجرى الحديث لنهر الفرات -أي عن مركز مدينة الناصرية- بحدود 10 أميال،. وهو ما يساوي 16 كم تقريباً.
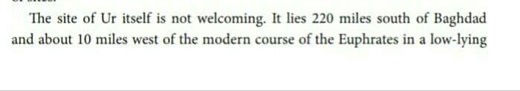
[الصورة من كتاب: أور، مدينة إله القمر لهارييت كروفوورد، الصفحة رقم 4].
كان من الأنسب أن أعود مرة ثانية لكتاب الأكاديمي العراقي الذي لا زلت أحسن الظن بعلمه، فربما لم أنتبه إلى أن وحدة قياس الطول التي استخدمها هي الميل أيضاً، لكنني وجدته -في سائر صفحات الكتاب- يعتمد القياس المتري، مثلما يفضل العراقيون. ذلك يجعل الفارق بين المصدرين ستة كيلو مترات، وهي مسافة ليست بقليلة. لكن لماذا نميل لتصديق المصادر الغربية، فليس ثمة ما يضمن عدم وقوعها في أخطاء هي الأخرى؟ هذا ما تأكدت منه لاحقاً، حين قمت بالبحث في كثير من المواقع الإلكترونية الغربية، فوجدت بعضاً منها -وإن على نحو قليل- يكرر شيئاً مما تقدم. كان الحلُّ الأخير بالنسبة لي هو الرجوع للإنسكلوبيديا البريطانية، وتحت عنوان (Ur) كانت المسافة هي 10 أميال (16 كم) أيضاً.
روح التسامح
كنت قد بدأت بالكتابة في الموضوع الذي نطالعه الآن قبل عام، مباشرة إثر نشر مقالي المشار إليه على هامش زيارة البابا، لكني قررت التوقف بعد بضعة أسطر. ربما بسبب الكم الهائل من الأخطاء التي تمر بنا يومياً، أخطاء لا نهاية لها، تتناسل في الكتب والصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، في الدراسات والأبحاث، في رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التي ينجزها طلبة الدراسات العليا تحت إشراف أساتذة يتلقون أموالاً لقاء عملهم، ويفترض أن يكونوا قد تأكدوا من كل حرف فيها قبل أن يجيزوها. قلت في نفسي: ما الجدوى من الكتابة؟ وما الذي ستضيفه كلماتي في حال أكملت المقال؟ هي لن تكون قادرة على الوصول لأولئك الذين استقبلوا المعلومات الخاطئة، ومن المؤكد أن أكثرهم قد أخذوها بوصفها حقائق، فهي صادرة من صحفيين وباحثين ومحللين وأساتذة أكاديميين، أي عمن يفترض أنهم يمثلون نخبة نجحت بامتلاك رأس مال معرفي يميزها عن الآخرين. لكن أور هنا ليست سوى مثال عن ظاهرة كبيرة مثلما قلت، ونحن للأسف لا نلتفت إلى خطورة آثارها.
بالأمس فقط، قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الأولى لزيارة البابا فرنسيس، قررت العودة للكتابة. وجدت نفسي أفكر في دلالة الاحتفاء بالمناسبة، في التسامح الذي تحتاج إليه مجتمعاتنا العربية أيَّما احتياج. التسامح بين الأديان والطوائف والأعراق بالتأكيد، وقبل ذلك فيمن يمكنه فهم فن التسامح، ويحسن التبشير به، بعد أن يجعل منه سلوكاً يُحتذى لا كلاماً شعاراتياً فارغاً، باختصار فيما له صلة وثقى بسلوك النخب العالمة، تلك المؤهلة أكثر من سواها لإشاعة ثقافة السلام واحترام الآخر، والأهم نبذ التعصب، لأنه النقيض المباشر لمعنى التسامح. ليس الخطأ عيباً بذاته، فهذا هو شأن الإنسان، ينتابه السهو، وتأخذه العجلة أحياناً، كمثال الأستاذ الأكاديمي الذي فضَّلت عدم ذكر اسمه هنا، وتجنب الإشارة لأسماء سواه أيضاً. أو كما كدت أنا نفسي أن أقع فيه لولا المصادفة التي قادتني للتنقل بين الفضائيات، ثم في وجود المصدر الغربي المشار إليه في مكتبتي، وانتباهي إليه لحظتها، من غير ذلك ما كنت لأصل إلى الحقيقة، ولا كان هذا المقال. ألا يشير ذلك إلى احتمال أن تكون كثير من قناعاتنا الراسخة التي تمنعنا عن قبول فكرة التعددية وقبول الاختلاف والتعايش معه قابلة للمراجعة والتعديل؟
في الواقع إن خطر المشكلة هو في الإصرار على الخطأ، وفي عدم التنبه إليه والاعتذار عن تبعاته. من بوسعه أن يمنحنا رقماً تقريبياً للأخطاء العلمية التي تم الاعتذار عنها، والمبادرة لتصحيحها؟ إن روح التعنت والمكابرة ستجعل المثقف عاملاً مساعداً على إشاعة الجهل، سواء أجاء ذلك بعلم منه أم لا. ومن بين ما يعنيه ذلك أيضاً أن النخبة يمكن أن تنشر الزيف بين الناس وهي تظن أنها تمارس دوراً توعوياً. وإلا كيف نفهم هذا التراجع السافر في المستوى العلمي لغالبية الشباب العربي، وذلك الإصرار على قناعات آيديولوجية كُلِّيَانِية تجاوزها الزمن، بينما لا تزال تنشط في فضائنا العربي لتبث البغضاء والكراهية. إنها بطبيعتها رافضة لمنطق التسامح، مع الذات ومع الآخر. من أجل ذلك عدت لكتابة المقال، بأمل أن يكون في الأمثلة التي تضمنها درس لنا جميعاً، وأولهم كاتب السطور، درس يوضح لنا كيف أن أكثر الناس خبرة وصلة بالواقع الثقافي، وأصحاب أعلى الشهادات هم بشر في المحصلة، يؤخذ منهم ويُرَدُّ عليهم، فما بالنا بمن صاروا اليوم، بعد التراجع السافر لدور الدولة من أبرز المؤثرين في الرأي العام، بزعيم الحزب ورجل الدين وشيخ القبيلة، أولئك الذين نجحوا باستعادة نفوذهم القديم، بينما تراجع دور النخبة إلى أدنى مستوياته. إنه العجز الثقافي، والوهم الذي يجعلنا نفكر بمنطق كل شيء أو لا شيء. ولأنَّ تراكم الأخطاء البسيطة لن يجعلنا بقبال أخطاء كثيرة فحسب، وإنما أمام خطايا، ها أنا أعود لتدوين هذه السطور، لعلها تلهم شاباً واحداً، تعلمه أن متبنيات الآخرين مثل متبنياته، أفكار نسبية، لا سبيل أمامها غير التعايش بسلام ومحبة. وأن تصل إلى هدفك متأخراً خير من أن لا تصل إليه أبداً.