"لقد حافظت على نفسي طوال حياتي من التلوث التجاري، كنت أبني نفسي بالقراءة والبحث والتعلم، ولقد مررت بلحظات كثيرة من الضيق الشديد نتيجة أنني لا أعمل". هذه العبارة لشادي عبد السلام (١٩٣٠-١٩٨٦)، قالها قبل وفاته بشهور، بحسب مجدي عبد الرحمن، أحد أصدقائه المقربين.
قرأت هذه العبارة منذ أكثر من عشرين عاماً، حين كنت في منتصف العقد الثالث من العمر، فلم أنتبه لما تحمله من وجع. وحين قرأتها من جديد قبل أيام، انتبهت لها، وكانت الدافع الأول للعودة إلى شادي، وبالتالي للعمل على هذا المقال.
الوجع، أو الضيق، الذي انتاب شادي عبد السلام، والمعبر عنه في هذه العبارة، يعرفه السينمائيون المصريون، نتوارثه من جيل لجيل، مع إحساس مبهم بالمرارة لأن شادي لم يستطع أن يستكمل مشروعه الفني، أو لم يسمحوا له أن يستكمله. هذا الإحساس المبهم بالمرارة يبرر افتقادنا للقدرة على التخلص من سطوة فيلم "المومياء.. ليلة أن تحصي السنين" (١٩٦٨) ومن هيبته كأيقونة، كإحدى أهم التحف في تاريخ السينما العربية، إن لم يكن التحفة الأبرز. وهي الهيبة التي تمنعنا بدورها من تحويله أخيراً لمادة للتفكيك والتحليل والنقد، وربما لإعادة التركيب.
كتب شادي عبد السلام فيلمه قبل هزيمة ١٩٦٧، وتم تنفيذه بعدها. سأله العديد من النقاد والصحفيين إن كان للهزيمة تأثير على الفيلم، فكانت إجابته بالتأكيد، دون أن يقدم ملامح ملموسة لهذا التأثير، فيكتفي بالإشارة إلى حالته النفسية السيئة جدا خلال تنفيذه، وبالذات بعد وفاة والده، لدرجة أنه لم يكن يطيق النظر إلى وجهه في المرآة أثناء حلاقة ذقنه صباحا.
فيظل السؤال معلقاً دون إجابة: كيف تنعكس الحالة النفسية للفنان، والناتجة عن حدث سياسي كبير وتاريخي، على منتجه الفني، على ما هو ملموس في هذا المنتج الفني، ونستطيع أن نرصده ونلاحظه؟ ويبدو أن مخرج المومياء يقرر لسبب ما، وبالرغم من تقديمه لتفسيرات كثيرة لجوانب أخرى من فيلمه، أن يترك هذه المنطقة تحديداً دون تفسير. أو أنه لم يملك التفسير الواضح الذي يستطيع تقديمه.
في حوار أجراه الناقد الراحل سامي السلاموني مع شادي عبد السلام، ونشر بعد وفاة هذا الأخير، يتجنب، كالعادة، وضع أيدينا على تأثير الهزيمة على فيلمه، لكنه يشير إلى ما هو أهم، فيقول "كل تفصيلة في الفيلم لها أصل ولها تفسير"! ويؤكد في هذا الحوار وغيره على غياب ما يسمي بـ"الارتجال" خلال تنفيذه لأفلامه، وأن طريقته في العمل تعتمد على التحضير الدقيق لكل التفاصيل قبل بداية تصوير الفيلم. بل إنه يكشف عن أن مرحلتي الكتابة والتحضير للتصوير هي فترتا متعته، حين يتخيل كل تفاصيل فيلمه ويبنيه داخله، وكأنه في رحلة خاصة بصحبته، رحلة ذهنية وإبداعية تحقق له المتعة الأساسية، لتأتي في نهاية هذه الرحلة مرحلة التنفيذ السهلة لتحقيق ما كان يعرفه عن فيلمه، في ذهنه وفي روحه وعلى الورق.
أن يكون لكل تفصيلة معنى وتفسير، أو بالأحرى وظيفة، مع غياب الارتجال، يجعلنا نضع سينما شادي عبد السلام في إطارها الملائم، باعتبارها سينما ذهنية، أو مفاهيمية، بامتياز. هذا النوع الذي يفتقد إلى فوضى أو تلقائية أو مشاعرية أعمال فنية أخرى. هذه السينما الذهنية التي قدمها شادي، واهتمامه بأن يكون لكل التفاصيل معنى وتفسير، هي على الأغلب من تأثير دراسته الأولى للعمارة، حيث لا يوجد شيء زائد أو مجاني، كل الحوائط والأعمدة والمساحات لها وظائف محددة. وهو ما يسحبه شادي عبد السلام إلى منطقتي البناء الدرامي، والشكل/الإطار.
علينا هنا التورط في جملة اعتراضية ضرورية؛ ينزع غير العاملين بالسينما، والمبتدئين في مجال عمل الأفلام، وبسبب إعجابهم الشديد بالسينمائي القادر على ترجمة كل المعاني والأفكار لأشياء ملموسة، الذي تجد في أفلامه تفسيراً لكل العناصر، إلى اعتبار السينما الذهنية هي "السينما" بألف لام التعريف. لكن هذه السينما الذهنية هي نوع من أنواع السينما، وإن كانت هذه الذهنية قد أنتجت تحفة مثل "المومياء"، فإن نتيجتها أحياناً أخرى كانت أفلاماً ميتة تشبه المعادلات الرياضية. وقد أنتجت الطرق الأخرى التي تنزع للتلقائية وتسمح ببعض الارتجال، تحفاً أخرى.
***
أذكر أننا شاهدنا "المومياء" خلال السنة الدراسية الأولى بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة، ١٩٩٦/١٩٩٧. أذكر أيضاً، وإن كان من المحتمل أن أكون مخطئاً، أننا، خلال نفس العام الدراسي، أو العام التالي، شاهدنا نسخة رديئة من فيلمه "آفاق" (١٩٧٢)، من ضمن منهج مادة السينما التسجيلية. وهو الفيلم الذي أثار اهتمامي أكثر من فيلم المومياء، الذي شعرت دائما بأنه وضع في مكانة تقديس، تفرض التعامل معه برهبة تجردك على الأقل من بعض الروح النقدية خلال تلقيه، وخلال مرحلة تأمله اللاحقة. بينما "آفاق"، ولأنه تسجيلي، ولأنه مجهول للكثيرين، يمنحنا بعض الحرية في تلقيه، في الإعجاب به من عدمه، يمنحنا الحق في تفكيكه وإعادة بنائه من جديد.

[المخرج شادي عبد السلام في صغره].
كيف تحكي فيلماً تسجيليّاً؟ الأفلام التسجيلية يتم حكيها عبر خطوطها العامة. إن حكيت عن فيلم "آفاق" فلن يكون هناك ما يمكن قوله أكثر من أنه فيلم تسجيلي في تسعة وثلاثين دقيقة، من إنتاج مركز الفيلم التجريبي، الذي كان يديره شادي عبد السلام، ويستعرض عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية في مصر أول السبعينات.
لكن هذا الملخص لا يقول أي شيء عن الفيلم، مثلما لا تقول هذه الجملة الدعائية/السياحية التي وُضعت على مغلف نسخة الفيلم التي أصدرها صندوق التنمية الثقافية بعد إنتاجه بسنين طويلة.. "الفنون الشرقية والغربية تتعانق في مصر الحديثة". وأعتقد أن هذه الجملة لا تنتسب بأي شكل من الأشكال لشادي عبد السلام.
وبالرغم من أن هناك رابطاً ملحقاً بالمقال لمشاهدة "آفاق"، فلنغامر بطريقة أخرى في حكي الفيلم، كي نستطيع تخيله قراءة، وملاحظة بعض التفاصيل المحتمل عدم تنبهنا إليها خلال المشاهدة، حتى وإن كان نتيجة المغامرة بائسة، فمن المؤكد أن أحد الجوانب الملهمة في مسار السينمائي والمثقف والفنان التشكيلي شادي عبد السلام هي شجاعته وقدرته على المغامرة والتجريب.
يبدأ الفيلم بعزف أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة يوسف السيسي، لافتتاحية "كارمينا بورانا". لا نقترب من الأوركسترا، نراها من بعيد، عبر ستائر تفتح وتغلق، نقترب قليلا دون أن تفقد الأوركسترا اكتمالها، لنبتعد من جديد. مع انتهاء الافتتاحية ننتقل إلى مدرسة الحرانية، نجد أنفسنا بين فلاحين يتحاورون مع الفنان الآتي من المدينة وأسس المدرسة، رمسيس ويصا. وهنا، نقترب حقيقة من وجوه الفلاحين وأيديهم وهم بصحبة أنوال الغزل. لننتبه فجأة إلى أننا قد أصبحنا في بيت الفنان حسن سليمان، تتحرك الكاميرا في بيته، لا نراه وهو يرسم، نرى بعضا من رسوماته الأقرب إلى التجريد، مع موسيقى غامضة. يخرج حسن سليمان إلي شرفته المعلق في سقفها مراكب مصنوعة من ورق ملون، يحركها بيده، تبدو طائرة، لنعود مرة أخرى للتجول في بيته عبر هذه الكاميرا التي لا تتوقف عن الحركة. يتغير الصوت تدريجيا، لتسود أصوات حيوانات في الريف. فمن تجريدية حسن سليمان ننتقل إلى تأثيرية يوسف كامل، الذي نراه وهو يرسم، ونتأمل بعض التفاصيل من لوحاته، وتصويره للريف وللفلاحين ولحيواناتهم. بقفزة نجدنا في دار الكتب، نتحرك في ممراتها الضيقة، هناك عدد من الباحثين، وهناك مخطوطات قديمة، مع صوت ابتهالات دينية، تختفي تدريجيا ليسود صمت لا تقطعه سوى بعض الخطوات التي لا نعرف مصدرها. تقودنا الشاشة المظلمة إلى مشهد جديد، بعض الحلي البدوية والأثرية من مقتنيات صلاح مرعي. لقطات كبيرة لهذه الحلي، مع إضاءة خافتة، وفي الخلفية أقمشة متعددة الألوان يطيرها الهواء، بينما نسمع لحنا شرقيا ننتقل عبره إلى فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة. الكاميرا أقرب للفرقة من درجة قربها السابقة من أوركسترا القاهرة السيمفوني. لا تتوقف عن الحركة الرأسية الدائرية التي تبدو منسجمة مع الجمل الموسيقية التي تتكرر بإيقاع ربما نستطيع وصفه تجاوزا بالدائرية. تتوقف الكاميرا عن الحركة أمام مشهد عام لباليه عبد المنعم كامل، الذي يرقص وفي الخلفية ما يبدو أنه رسم عملاق لريف أوروبي.
لقد وصلنا إلى منتصف الفيلم تماماً، نتجول بين أنقاض لبيوت ومبان مهدمة، لا نعرف أين يقع هذا الخراب. تواصل الكاميرا حركتها حتى تتوقف بلقطة قريبة، تتسع تدريجيا بتراجعها البطيء إلى الوراء، وأمامنا على خشبة مسرح "ستوديو الممثل" يؤدي محمد صبحي دور هاملت، في مواجهة أمه التي تؤدي دورها الممثلة نيفين، وظهور شبح الأب. وهو المشهد الوحيد من "آفاق" المتضمن لكلمات.
من هاملت شكسبير نصل إلى قصور ومدارس القاهرة الإسلامية، حرف يدوية، نرى أطفالاً عن قرب وهم يتعلمون هذه الحرف، أو نرى أياديهم وأيادي أساتذتهم تحتل الشاشة في لقطات كبيرة تجعلك تشعر وكأنك قادر على لمسها، أيادي عازفي القانون والعود دون أن نرى وجوههم، ساحات ونوافير لقصور مملوكية، مشربيات، نقوش ملونة على النوافذ الزجاجية، نتأمل عواميد جامع أثري بينما هناك شيخ يشرح لبعض الأطفال شيئاً ما عن الجامع، مراسم للفنانين في منطقة الغورية، نشاهد بعضا من أعمالهم دون أن نقترب منها أو نراها بوضوح، وتختلط بتفاصيل من هذه القصور. لكن هناك لوحة وحيدة نراها بوضوح.. شخص مستلق، يشكل بجسده خط الأفق، أفق التقاء أرض وبحر وسماء.
أوركسترا جديدة، موسيقى أقرب إلى الجنائزية، فهي قطعة "أداجيو" لألبينوني. لقطة واسعة لأرغن نراه من بعيد، تقوم الكاميرا بعمل دائرة كاملة حول الأوركسترا، لتنتهي الدائرة بنفس تكوين الصورة الأولي للأرغن. لنجد أنفسنا فجأة في صحراء، منحوتات آدم حنين التجريدية، التي تفتقد للملامح الواضحة، لكنها لأشخاص موزعين بين الرمال يتطلعون إلى اتجاهات مختلفة ومتناقضة، وآخر ما نراه منها هو أحد تماثيله الشهيرة للرجل الجالس بينما تغطي يداه عينيه، أو ربما تحيط بها كي يري بصورة أفضل. نتأمل هذا العمل عبر تموضع الكاميرا أمامه مباشرة، دون حركة، ينتصف الكادر تماماً ويكتمل بداخله، مع عودة تدريجية لموسيقى "أداجيو"، واللقطة العكسية لتمثال أدم حنين، الذي يبدو أنه ينظر إلى الصحراء، أو يحاول تجنب رؤيتها.
***
لم يبخل شادي عبد السلام بتقديم تفسيرات لأفلامه، سواء كان المومياء، أو الفيلم الذي لم يكتمل عن أخناتون "مأساة البيت الكبير"، أو الأفلام القصيرة الأخرى. فسنجده يوضح على سبيل المثال في عدد من الحوارات أن سينماه ليست واقعية، بل أنه واضح في التصريح بأن السينما الواقعية لا تستهويه، ويمنح جمهوره مفتاحا للدخول لفيلم المومياء وفهمه، حين ينبههم إلى أنه عمل فني تجريدي، يتخلى فيه عن كل التفاصيل الواقعية التي يستطيع التخلي عنها، ليتحدث عما هو أهم من الحدوتة المباشرة لهذا الشخص الذي أبلغ مفتشي الآثار بالمكان السري للمومياوات التي تعيش قبيلته على نهبها وبيع كنوزها. فهو مهموم بعلاقة الفرد بالعملية التاريخية، ويؤكد على أن أبطاله لا يكتسبون بطولتهم سوى في علاقتهم بلحظة تحول مفصلية في التاريخ.
المفارقة هنا أن شادي عبد السلام الذي لا تستهويه السينما الواقعية، أنجز فيلمه الأهم بفضل روسيليني، أحد أهم رواد السينما الواقعية على مستوى العالم. وتكتسب هذه المفارقة وجهها المرير حين يكون مواطنو شادي عبد السلام المسؤولون عن الثقافة، الوزير ثروت عكاشة تحديداً، هم من كانوا يجهلون شادي، بينما كان يعرفه روسيليني ويعرف أهمية السيناريو الذي يريد تنفيذه.

[المخرج شادي عبد السلام].
بعيداً عن هذه المفارقة، وبالعودة إلى علاقة الفرد بلحظة تحول، نستطيع أن نضع "المومياء" في لحظته التاريخية، ١٨٨١، قبل الاحتلال الإنجليزي بسنة، وإجهاضه لمشروع صحوة قومية ومشروع استقلالي يعتمد على وعي متنام بالهوية المصرية. ويتم تنفيذ الفيلم خلال مرحلة تاريخية عنوانها الأساسي هو الهزيمة بعد حرب ١٩٦٧. بينما يتناول لحظة تحقق مركبة تتضمن المرار والضياع، وهي لحظة اكتشاف "ونيس" (أحمد مرعي) للسر التاريخي لقبيلته، وما يصاحب هذا الاكتشاف من إحساس بالعار، وبالانتماء إلى هؤلاء الأجداد الذين يتم نهب آثارهم وتوابيتهم، والتحول الضخم في مساره خلال أربعة وعشرون ساعة، أو بكلمات أخري اكتمال هويته المصرية، ليصبح ونيس الملعون من أهله، لكنه المنقذ لتراث ومجد الأجداد. وهي أيضا لحظة التقاء المثقف الآتي من المدينة، أول مفتش أثار مصري "أحمد كمال (محمد خيري)، بابن منطقة الصعيد التي وصفها شادي دائما بأنها مصر الحقيقية التي يشعر بأنه أقرب إليها.
سخاء شادي عبد السلام في منح المفاتيح لفهم "المومياء"، وفهم لحظته التاريخية، هو ما يدفعنا للبحث عن تفسيره لفيلم "آفاق". في شهر فبراير من عام ١٩٩٦ خصصت مجلة "القاهرة" الشهرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عددها للسينمائي شادي عبد السلام، مع إعادة نشر لكتاب طه حسين "في الشعر الجاهلي"، وبعض الوثائق المتعلقة بقضية الدكتور نصر حامد أبو زيد. سنجد أن من ضمن ما يقارب أربعمائة صفحة مخصصة لعمل شادي عبد السلام، وتشكل غالباً المرجع الأهم عنه، هناك إشارة واحدة وسريعة لفيلم آفاق! وهي إشارة يستعيدها مجدي عبد الرحمن علي لسان شادي، أن فكرة الفيلم بدرت من مسؤولي وزارة الثقافة بعد توليه لمسؤولية مركز الفيلم التجريبي، مقترحين عليه أن ينفذ فيلماً عن الأنشطة الثقافية والفنية التابعة للوزارة. ويتابع "كان المقصود طبعاً عمل فيلم من النوع الإعلامي. [أعتقد أنه يقصد بتعبير "إعلامي" دعائي]. في البداية تهربت من الموضوع لمجرد أن قيل لي أن أعمله ولم يأت مني أنا.. قالوا: عاين الموضوع بنفسك. استعرض النشاط وتأمله ثم قل رأيك بعد ذلك.. قبلت متردداً. أمضيت سنة أصور بعض أوجه النشاط ثم أتوقف.. كانت البلد في حالة حزن وقرف بسبب النكسة ووجدت أن الذي يقوم بالنشاط الثقافي إلى جانب الهيئات أفراد وأطفال وبدأت أكتشف أن هناك حياة تدور رغم الكابوس". ويشير شادي إلى أن المشروع تبلور في ذهنه من هذه الزاوية، أن يقدم ملامح من منتجات وأنشطة بعض الأشخاص والمجموعات من داخل وخارج الوزارة "كي أقول إن القاهرة بناسها تحيا رغم كل شيء، تتنفس الثقافة والفن".
لا تمنحنا هذه الإشارة الوحيدة للفيلم من قبل شادي عبد السلام مفاتيح ممكنة للدخول إلى عالمه. ربما نجد هذه المداخل في مسار المخرج نفسه، أو عبر آرائه التي صرح بها في أكثر من مقابلة، أو في المرارة التي احتفظ بها، وعبر عنها كثيراً، تجاه الموظفين البيروقراطيين المتحكمين في وزارة الثقافة. فنجد أن من المستبعد استجابة شادي عبد السلام لتكليف بتقديم هذه الدعاية لأنشطة الوزارة، أو أن يكون عمله مجرد رصد لبعض هذه الأنشطة. بل إن الفيلم منذ بدايته، وبطريقة بنائه، واعتماده على التناقضات أحيانا، ومنطق التداعي في أحيان أخرى، للانتقال من مشهد لآخر، من مكان لآخر، واستخدام بعض المشاهد واللقطات التي لم أوردها في السرد السابق الذي قدمته كتتابع مختصر للفيلم، يدعو المتفرج إلى القلق، والتأمل، والتساؤل حول ما يراه. ويدعوه أيضاً أن يذهب بصحبة مخرجه في رحلة للبحث عما يسميه هو بالـ"آفاق"، فربما يجدونها سوياً، أو يفشلان.
***
الهزيمة العسكرية والسياسية الحاضرة بثقلها الشديد وقت تصوير المومياء كانت حاضرة أيضاً، وبثقل أكبر، وقت تنفيذ فيلم "آفاق"، منذ بداية الإعداد له وحتى إنهائه. نستطيع أن نضيف للهزيمة العامة التي وصفها هو بـ"كانت البلد في حالة حزن وقرف".. إيقاف حرب الاستنزاف وموت عبد الناصر، مسار السادات المقلق للمثقفين والفنانين المصريين وقتها، محاولة تجنبه لخوض حرب التحرير، توقف الدولة عن الإنتاج السينمائي الذي كان شادي عبد السلام من الداعين لاستمراره والمنبهين لضرورته، لدرجة دعوته الدولة لتعيين كل خريجي معهد السينما كي يقوموا بتنفيذ أفلامهم، بداية الحركة الطلابية الاحتجاجية من جديد في يناير ١٩٧٢. بالإضافة إلى إحساسه هو بالمرارة تجاه موظفي وزارة الثقافة، الذين طالبوه بأن يصنع فيلم آفاق. فبعد تنفيذه للمومياء بالرغم من كل محاولاتهم لعرقلته وإيقافه، ومحاولاتهم ألا تمنحه الرقابة تصريح التصوير بناء على شهادة الرقيب مصطفي درويش، وبعد ترويجهم لصورة سلبية عنه مفادها أنه مخرج شديد البطء في العمل، يعود من جولة أوروبية وضعت فيلمه في المكانة التي يستحقها باعتباره عملاً فنياً شديد التميز، ووضعته هو في مكانة السينمائي الذي لا يدين لأحد قبله، ولا يدين لسينما سابقة. لكن بيروقراطيي الوزارة يعرقلون عرض الفيلم على جمهوره الطبيعي، المصري، بالرغم من نجاحه في الخارج، بحجة أنه سيفشل تجاريا! بينما تمتلك الوزارة قاعات للعرض السينمائي مفترض أن يكون هدفها نشر الثقافة وليس التربح تجاريا. فيتم تخزين/ركن الفيلم لسنوات أخرى.
في هذه اللحظة لالتقاء الهزيمتين الشخصية والعامة يصنع شادي عبد السلام فيلم آفاق، تاركاً بعض الإشارات التي تدفعنا لأن نتساءل إن كان هو أحد أبطال فيلمه المتفاعلين مع لحظة تاريخية كبرى، سواء ظهر بجسده في الفيلم، أم لم يظهر.
***
في ١٩٦٧ هزمت السلطة عسكرياً، وانهار مشروعها التنموي والقومي بعد أن عزلت المثقفين عنه، وتركت العسكريين والبيروقراطيين يتحكمون به. وهو ما يجعلني أتساءل عن موقع السلطة داخل فيلم "المومياء".

[أثناء تصوير فيلم "المومياء"].
تركزت أغلب التحليلات لشخصيات المومياء والعلاقات فيما بينها على ونيس وأحمد كمال. وتناول بعضها زينة، أو العم، أو الأخ، أو تاجر الآثار، أو الفلاح الغريب الآتي من قرية أخرى. بينما هناك شخصية رجل الأمن، ممثل السلطة، الذي يبنى دراميا وفي طريقة الأداء كي يعبر عن بعض الفظاظة. وتظل هذه الفظاظة غامضة دون تفسير منذ ظهوره الأول وحتى تحيته لمفتش الآثار الراحل بالمومياوات على ظهر المركب. بل أن هناك تناقضاً بين المثقف الآتي لاكتشاف اللغز ورجل الأمن في كيفية التعامل مع ونيس، هذا الشاب المنتمي للقبيلة والآتي للبوح بالسر. يريد المثقف أن يستمع، أن يكتشف ونيس، بينما رجل السلطة لا يهتم بونيس، يتشكك فيه، يراه كخصم، يتعامل معه من أعلى، من فوق حصانه، وصولا للنقطة التي يستطيع فيها المثقف أن يفرض على رجل السلطة أسلوبه، فيتحول لمجرد شخص يكرر بآلية أوامر المثقف.
إن افترضنا أن العلاقة بين رجل السلطة الفظ والمثقف الراغب في اكتشاف الحقيقة هي إحدى صور تأمل شادي عبد السلام لمعضلة علاقة المثقفين بالسلطة التي شغلت جيله، وبالذات خلال السنوات الأخيرة من حكم عبد الناصر قبل وبعد الهزيمة، فسيمكننا إذا افتراض أن فيلم آفاق كان تمجيداً لهذا المثقف قبل هزيمته الأخيرة، قبل أن يصل المثقف شادي عبد السلام، بحسب المقربين إليه، إلى قناعة أنه لم يعد صالحاً للعمل في هذا الزمن، وأن ما يود تقديمه لم يعد مناسباً.
***
حكيت الخطوط العامة لـ"آفاق"، أو لنقل مشاهده الأساسية. حكيت ما لا يبتعد كثيراً عما كان يريده موظفو وزارة الثقافة حين كلفوا شادي به. لكن هناك ما يخصه ولم أحكه، وهناك مفاصل أساسية لها دلالاتها تربط بين هذه المشاهد، ليست أنشطة ثقافية أو إبداعية بالمعنى المباشر، ولا يمكن أن تكون مجرد زيادات عند مخرج ينزع إلى التجريد، ويرى أن كل العناصر في سينماه يجب أن يكون لها معنى وتفسير.
يشير شادي عبد السلام إلى أن حالة البلد كانت رديئة بسبب الهزيمة، لكنه وجد أن ناس القاهرة يتنفسون الثقافة والفن، إنتاجاً واستهلاكاً. لماذا إذا الصحراء التي يختتم بها فيلمه؟ تظهر في المشهد الأخير وتكون الأفق الوحيد الملموس بالمعنى المحدد لكلمة أفق! بينما تعني الصحراء في ثقافتنا الجفاف، الموت، خطر الفناء، القسوة، وربما التيه. لا نراها كصحراء السفاري والسحر والسهر مثلما يراها السياح. ولماذا مشهد الخراب الذي يظهر في منتصف الفيلم وكأنه يحدد نقطة توتره الدرامية الأعلى؟
وبينما لا يتركنا السينمائي لنرى بوضوح أغلب اللوحات التشكيلية، نتمكن من رؤية رسم لقضبان على شباك، تبدو كقضبان زنزانة أو غرفة قديمة يحملها شادي بين يديه. نعم، لا يوجد أي خطأ في الجملة السابقة، فإن شادي عبد السلام يظهر بنفسه في الجزء الأخير من الفيلم. ففي مراسم الفنانين في القاهرة الإسلامية نرى بالترتيب حامد ندا، عبد الوهاب مرسي، عز الدين نجيب، ومحمد نبيل. بينما هناك فناناً آخر لا يظهر اسمه على تيترات المقدمة، يدخل بصحبة محمد نبيل، يحمل في يده لوحة، يتجهان سوياً إلى عز الدين نجيب الجالس في عمق المكان ليرسم، فيقوم هذا الفنان بعرض لوحته أمامهما، ولقطة أخري نراها عن قرب: قضبان متقاطعة. لتنتقل الكاميرا مباشرة إلى داخل غرفة صغيرة، وعلى شباكها نفس القضبان التي تفصل بين عالمين، عالم منهما مغلق داخل الغرفة، وعالم آخر بالخارج، يبدو مضيئاً، لكننا لا نراه بوضوح. وهذا الفنان هو شادي عبد السلام نفسه.
لقاء هاملت بشبح الأب ومواجهته لأمه هو مشهد محوري داخل الفيلم، ليس فقط لأنه الوحيد المتضمن لكلمات، بل أيضاً لطريقة إخراجه، والاقتراب الحميم من ملامح الممثلين وتعبيراتهم، والابتعاد عنهم لاحقاً، وإنهائه بمشهد عام مهيب وكأننا في معبد يتضمن المسرح والسينما معاً. فلنتذكر معضلة هاملت الأساسية: معرفة الحقيقة، الانتقام، والأهم: أن يكون أو لا يكون، أن يتحقق. الانتقام في هذه المسرحية هو هدف أو حجة درامية كي يخوض هاملت الرحلة، وكي نخوضها معه. لكن الهم الأساسي هو اكتشاف الحقيقة والتحقق. وهو نفس هاجس ونيس، ومفتش الآثار، وشادي عبد السلام الذي ينزع للتجريد بحثاً عن الحقيقة، وعن الجمال، وعن المعنى الخالص، دون أي بهرجة أو زوائد أو ألعاب شكلانية، سواء في المومياء أو حين يأخذنا معه في رحلة لتأمل الثقافة والفن أول السبعينات.
بالإضافة إلى حضور شادي عبد السلام جسدياً في الفيلم كفنان تشكيلي، تحضر كاميرته، ويحضر كسينمائي عبر "آلتر إيجو"/معادل درامي يجسده محمد صبحي الذي يحمل في يديه الكاميرا بالإضافة لتجسيده لدور هاملت على المسرح. ومنذ تيترات البداية متنوعة الألوان لتقديم الشخصيات والأماكن التي سنراها في الفيلم، نسمع على شريط الصوت مزيجا من نوعين من "الضوضاء". بالتركيز فيهما سنجد أنهما لأوركسترا تستعد للعزف، ويقوم عازفوها بضبط آلاتهم الموسيقية، وفريق سينمائي يستعد للتصوير. ينبه أحدهم الآخرين إلى أن العمل سيبدأ، يطالبهم بالهدوء، لنسمع صوت الكلاكيت، وتدخل موسيقي كارمينا بورانا. لكن قبل أن نرى الأوركسترا، يتم الافتتاح بلقطة كبيرة لعدسة كاميرا سينمائية تواجه الكاميرا الأساسية التي سنرى عبرها هذه المشاهد والشخصيات، كاميرا تتجه إلينا – مجازيا - لتقوم بتصويرنا نحن من نشاهد الفيلم، أو من نصاحب شادي عبد السلام في رحلته.
منذ الافتتاح بلقطة العدسة، وصولاً للختام بالفريق الذي يحمل أدوات التصوير ويغادر الصحراء، يتكرر هذا الحضور لكاميرا شادي عبد السلام. وإن لم تحضر الكاميرا ستظهر أدوات سينمائية أخري كالميكروفون وقضبان الشاريوه/(قضبان تتحرك فوقها الكاميرا). فيضعنا شادي عبد السلام أمام طرق متعددة لتفسير هذا الحضور. من بينها كسر الإيهام، كسر الجدار الرابع بالمعنى المسرحي، وأن يذكرنا المخرج بوجوده وأننا نرى الحقيقة التي يريدنا أن نراها. أو أنه يريد تذكيرنا بفن السينما في فيلم يتناول بعض أوجه النشاط الثقافي والفني.. من مسرح، وفن تشكيلي، وحرف يدوية، و موسيقى متنوعة، وباليه. . .إلى أخر كل التعبيرات المتضمنة في الفيلم. أو أن يكون لهذا الحضور للكاميرا والأدوات السينمائية دور وظيفي، وبالذات في النصف الأول من الفيلم، وهو التأسيس الأسلوبي منذ البداية لمن هو الراوي/العين الذي نرى من خلاله ما يحدث في الدراما، بحيث يكون راوي الفيلم هو السينمائي الذي نري عبره المنتجات الثقافية والفنية، والذي لن يتوقف مع كاميرته عن الحركة والبحث والقلق.
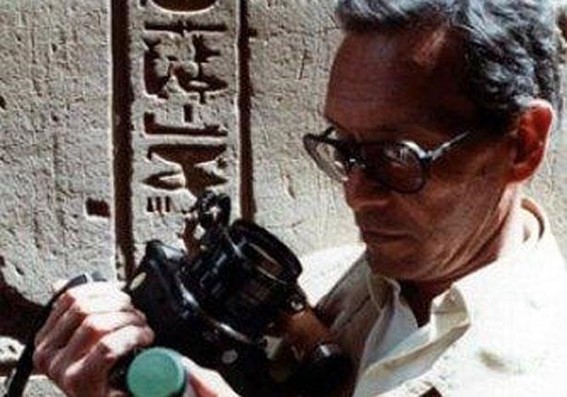
[المخرج شادي عبد السلام].
إلا أن الظهور المتكرر للكاميرا، وتحولها لما يشبه شخصية تلاحق الكاميرا الأساسية، أو لنا بالمعنى المجازي، مثلما يحدث على سبيل المثال في طرقات دار الكتب، ربما نجد له معنى إضافياً بالعودة إلى سؤال أساسي حول اسم الفيلم، "آفاق". وهو الاسم الذي يدعونا كمتفرجين لأن نتساءل أثناء المشاهدة، وبعد انتهائها، عن الآفاق التي نراها، وأين هي.
الأفقان الوحيدان في الفيلم بالمعني المباشر والحرفي للكلمة، هما أفق الرجل المرسوم في اللوحة مستلقيا أو ميتا، وأفق الصحراء التي تعني رمزيا الموت أو الفناء أو الضياع. وبينما نرى بعض التعبيرات الثقافية والفنية من بعيد دون أن نشعر باقتراب حقيقي منها، وتفصلنا عنها ستائر أو ظلال، أو ربما تنبهنا أن هذه التعبيرات ستختفي.. نقترب بحميمية من تعبيرات أخرى ومن مبدعيها، كوجوه الأطفال والبسطاء والفلاحين الذين يصنعون شيئا، ومن أياديهم بينما تصنع هذا الشيء، حتى وإن كان الفعل هو مجرد جلوس الأطفال للقراءة في فصل دراسي، أو ذهابهم للمدرسة بينما تظللهم الأهرامات. فربما يكون عبر هذه الكاميرا التي لا تتوقف قصد عن الحركة، والتي تصورنا وتلاحقنا، يحاول أن يجعلنا جزء من فيلمه، أن يقول لنا "لا تبحثوا عن الأفق، بمعنى الوجهة أو المستقبل، في التعبيرات الثقافية والفنية التي ترونها أمامكم مباشرة، فربما يكون بداخل كل منا أفق، فيما نصنعه بأيدينا، وليس فيما نقلده".
***
يعترف شادي عبد السلام بأنه تعلم كثيرا من روسيليني، لكنه لا يصنع سينما واقعية مثل روسيليني. وكان هاجسه أثناء عمل "المومياء.. ليلة أن تحصى السنين" أن يكون فيلمه مختلفاً تماما عن كل ما سبقه من حيث الأسلوب ومن حيث المرجعية البصرية والإيقاعية، وأن يصل عبره إلى بعض ملامح سينما مصرية لا تجد مرجعياتها في السينما الأمريكية، أو في أي سينما أوروبية، بل في ثقافاتنا، فيغامر في السينما مثلما غامر بطله ونيس بالبحث عن حياة جديدة تماما مفترقا عن أهله، ومثلما غامر أحمد كمال بأسلوب جديد في البحث عن الأثار في طيبة وحل لغز البرديات المهربة.
يفتتح شادي عبد السلام "آفاق" بفخامة "كارمينا بورانا"، لكنه يختتمه بالموسيقى الحزينة لـ"أداجيو"، يختتمه بتصاعد في نبرة الحزن، أو الشجن، التي تسيطر علي كل النصف الثاني من فيلمه، وبجنائزية تذكرنا بنهاية "المومياء"، حين ترحل التوابيت إلى مستقر جديد محمولة على أكتاف أهل الوادي، في مشهد جنائزي مهيب. لكن.. لا وجود لتوابيت ومومياوات في "آفاق"، هناك تماثيل آدم حنين العصرية، المجسدة لبشر ليس لهم ملامح واضحة، متروكين في الصحراء، متطلعين لآفاق مختلفة.
نعرف أن "كارمينا بورانا" موسيقي كلاسيكية. وتعني الكلاسيكية هنا من ضمن معان أخرى أنها قديمة. لكن كارمينا بورانا موسيقي معاصرة وضعها الألماني "كارل أورف" بين عامي ١٩٣٥ و١٩٣٦، من نوع الـ"كانتاتا"، أي الموسيقي التي تعتمد على نصوص مغناة. وهذه النصوص التي استخدمها كارل أورف من العصور الوسطى، منسوبة للمتمردين والخارجين عن سطوة وسلطة الكنيسة، الراغبين في حياة أكثر تحررا، نصوص تمجد المتعة واللذة والحب. وكأن شادي يكرر دعوة "المومياء" بشكل مختلف.. أن نلتقط تاريخنا القديم وأن نبدع بناء عليه ما هو جديد، أن نصنع كارمينا بورانا التي تخصنا، دون أن نقلد ما صنعه الآخرون، فربما عبر هذا الطريق نجد آفاقا أكثر رحابة وتنوعا للخروج من الهزائم.
ملحوظة ختامية: قدم شادي عبد السلام فيلمه "آفاق" منذ خمسين عاما. حرصت في هذا المقال أن يكون للهزيمة معنيان محددان، هزيمة ١٩٦٧ وتطوراتها في بدايات عهد السادات، وهزيمة شادي واحساسه بالضيق والوجع، الذين استمرا غالبا حتى وفاته دون أن يتمكن من تنفيذ مشروعه الأكبر "اخناتون" أو "مأساة البيت الكبير". وحاولت أن أتجنب الاقتراب من الهزيمة الثالثة، هزيمتنا نحن، حين نتأمل هذه المنتجات الثقافية والفنية الواردة في "آفاق"، والمتجسدة فيه كفيلم، ونقارنها بحالتنا الآن، بعد خمسون سنة.
رابط مشاهدة فيلم آفاق.