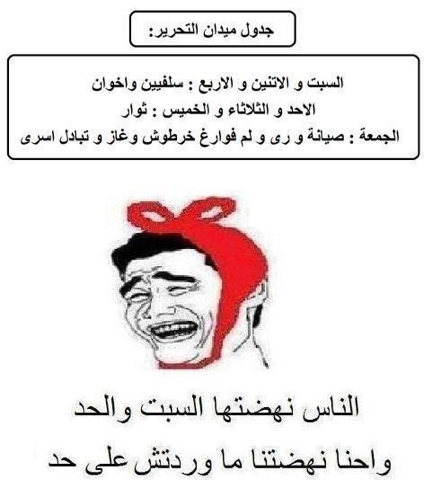تتجه أنظار السودانيين الى فبراير/شباط المقبل لمعرفة امكانية تحقيق الوعود التي أطلقها وزير المعادن الشاب، أحمد الصادق الكاروري، ببدء الإنتاج الحكومي من الذهب بمشاركة روسية. ففي أواخر يوليو/تموز المنصرم، أعلن عن التوقيع على عقد بين الوزارة والشركة الروسية "سيبريا" بحضور الرئيس عمر البشير شخصياً، مما يشير إلى الأهمية التي أسبغت على المناسبة. وفي حفل التوقيع نفسه تحدث الوزير عن الاحتياطيات الضخمة المكتشفة من الذهب التي سيجري العمل للبدء في إنتاجها من موقعين في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، حيث يمكن للموقع الأول أن ينتج ثمانية آلاف طن والثاني 36 ألفاً، ولو أن التوقيع مع شركة سيبريا الروسية أقتصر حتى الآن على الموقع الأول فقط. الوزير أوضح أن نسبة الحكومة من العائد ستصل إلى 75 في المئة وسيكون الباقي للشركة، كما أضاف في تصريحات لاحقة ان الشركة ستقوم بموجب العقد بتوفير مبلغ خمسة مليارات دولار في شكل قرض من مؤسسات التمويل العالمية، بضمان الذهب المنتَج.
موجودة أم شبحية؟
أثارت هذه الإعلانات العديد من علامات الاستفهام التي اشتعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بل وشارك فيها وزير سابق للمعادن عبَّر عن حيرته بخصوص الأرقام الكبيرة التي أعلنها خلفه. بدأت حملة التساؤلات بملاحظة تجاهل وكالات الأنباء العالمية، وخاصة تلك المهتمة بالشأن الاقتصادي مثل رويترز وبلومبيرغ، وهي كلها لها مراسلون في الخرطوم، خبراً بهذا الحجم يمكن أن يكون له تأثيره في تجارة الذهب العالمية. الرواية السائدة ان مراسلي الوكالات الأجنبية بعثوا بالخبر الى رئاساتهم التي أستقصت عن اسم الشركة الروسية المعلن في الخرطوم.. فلم تجد لها أثراً في موسكو، وكان أن أهملت الخبر.
ردت الوزارة ومدير الشركة الروسية بأن القوانين السودانية تفرض تسجيل الشركة في السودان وقد تم ذلك بأسم مختلف عن أسم الشركة الأم في روسيا. على ان بعض الباحثين قاموا بالتنقيب عن سجل تلك الشركة الأم ووجدوا ان تاريخ تأسيسها يعود الى العام 1992، كما انها مرت بفترات من التعثر المالي أثر التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها روسيا في تلك الفترة، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ثم سُجلت في لندن وكل ما عملت عليه في ميدان الذهب لا يتجاوزإنتاج طن ونصف الطن، وأهم من هذا ان الحكومة الروسية تملك نسبة 66 في المئة من أسهم هذه الشركة من خلال غازبروم بنك، وهي إحدى المؤسسات الاقتصادية الروسية الخاضعة للمقاطعة الغربية بسبب الصراع في أوكرانيا.
الوزارة ردت بأن للشركة سجلاً من النشاط التنقيبي عن الذهب في السودان يعود الى العام 2013 حيث استخدمت القمر الصناعي الروسي وتقنيات أخرى للمساعدة في الرصد المبدئي لحجم الاحتياطي ورسم الخرائط، وأتْبعت ذلك بعمل ميداني وحفر 600 حفرة في الموقع خلال هذه الفترة، وتجميع كل المعلومات وأخذ العينات وتحليلها ومن ثم الوصول الى التحديد الأولي لحجم الاحتياطي ووضع خطة للإنتاج تبدأ بعد ستة أشهر من التوقيع على العقد، ليبلغ 32 طناً بنهاية العام الأول ثم يرتفع الى 53 طناً في العامين التاليين.
إفادات الوزير لم تنجح في إشاعة الطمأنينة خاصة مع الارتباك الواضح في التعامل الإعلامي مع عدد الأسئلة المتفجرة حول الصفقة. وأخيراً اعتمد المسؤولون إستراتيجية تقول إن الدولة لن تخسر شيئاً لأن العقد لا يلقي عليها تبعات مالية. وفي وجه المقاطعة الاقتصادية الغربية بقيادة الولايات المتحدة، فإن خياراتها أصبحت محدودة، وبالتالي فيمكن الانتظار فترة الشهور الستة "والمية تكذِّب الغطاس" كما يقول التعبير الشائع. وهكذا أصبح استغلال ذهب السودان في انتظار الغطاس الروسي.
طوق نجاة اقتصادي
عُرِف السودان منذ آماد تاريخية سحيقة بأنه موطن لثروات معدنية عديدة من بينها الذهب. وفي مادة التاريخ التي يدرسها الطلاب في المدارس أن محمد علي باشا بعد أن أستقر له الأمر في مصر وخطط للتوسع، اتجهت أنظاره إلى السودان، حيث أرسل بعثات عسكرية جلباً للمال والرجال. والمال إشارة الى الذهب، لكنه لم يعثر على الكميات التي كان يأمل فيها. وحتى عندما عادت مصر لاستعمار السودان في شراكة مع بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر، وقع معظم العبء المالي للإدارة الاستعمارية على مصر.
لم يعد للذهب شأن يُذكر إلا قبل خمس سنوات عندما تصاعد نشاط التعدين الأهلي في مختلف مناطق البلاد، وقُدِّر عدد العاملين فيه في فترة من الفترات بأكثر من مليون شخص، نجح كثيرون منهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. ويقدَّر أن ذلك الجهد وأنشطته المصاحبة أصبح يعود على الخزينة العامة بنحو ملياري دولار سنوياً. أكتسب هذا الوضع أهميته من ناحيتين: اذ تزامن تصاعد نشاط التعدين الأهلي عن الذهب مع الصدمة الاقتصادية الناجمة عن انفصال جنوب السودان في العام 2011، حاملا معه نحو 75 في المئة من الاحتياطيات النفطية المعروفة في البلاد، ومعها بالطبع عائداتها من العملات الصعبة وكانت تغطي نحو 90 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، الى جانب نصف دخل الخزينة العامة. كذلك فقد تزامنت هذه الفترة مع اشتعال ثورات الربيع العربي. وفي تعقيب للنائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح في مؤتمر صحافي له مؤخراً، أنه لولا التعدين الأهلي للحق السودان بركب الدول التي تعرضت الى تلك الانتفاضات.
وفي الواقع، فإنه وحتى قبل بدء عمل الشركة الروسية، فإن إنتاج الذهب شهد تصاعداً. وصرح وزير المعادن انه في الشهرين الأولين من 2015، بلغ الإنتاج من الذهب 17 طناً، ويتوقع له أن يبلغ 80 طناً بنهايته. وكان 74 طناً في العام الماضي، بل وتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج 100 طن العام المقبل.
ويشير تقرير لصندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد السوداني انه يتوقع نمواً له بحدود 2.9 في المئة هذا العام، وأن أحد أسباب هذا النمو هو النشاط التنقيبي في مجال الذهب، حيث أصبح يشكل 70 في المئة من الصادرات بعدما كان 10 في المئة خلال فترة السنوات الأربع الماضية. ويحتل السودان حالياً المرتبة الثالثة في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا، وإذا سارت عمليات الإنتاج بمعدلاتها الحالية، وأضيف اليها ما يمكن أن تنتجه الشركة الروسية، فمن المتوقع أن يحتل السودان المرتبة الأولى في إنتاج الذهب في غضون عامين أو ثلاثة.
أبعاد دولية
أدى ظهور نشاط عمليات البحث عن الذهب في إقليم دارفور المضطرب إلى لفت الأنظار، لدرجة أدت الى هجرات إليه من دول مجاورة مثل أثيوبيا وأريتريا وتشاد ومالي. كذلك أدى ظهور النشاط التنقيبي في دارفور الى تصاعد الاقتتال القبلي بين بعض المليشيات المحلية التي تنقلت بسلاحها بين الولاء للحكومة وللمتمردين عليها، بسبب شعور شائع بينها ان الزعامات التي كانت تقاتل الى جانبها حصلت على وظائف وامتيازات شخصية من الحكومة بينما لم ينعكس ذلك على الناس العاديين. أما مؤسسة "كفاية" الأميركية التي أسسها جون برندركاست، الذي قام مع نشطاء آخرين بدور رئيسي في دعم حركة التمرد في السودان، والمعاونة في انفصال جنوب السودان، فأصدرت تقريراً مطلع هذا العام يدعو الإدارة الأميركية الى قيادة حملة لتسليط الضوء على الذهب المنتَج من مناطق النزاعات مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، واعتباره مساهماً في تأجيج الصراع. وأبلغ برندركاست إحدى لجان الكونغرس برأيه ذاك قبل بضعة شهور، ملمحاً إلى أنه بما ان هناك سيطرة من قبل بنك السودان المركزي على عمليات تجارة الذهب وعائداته تُستخدم في تمويل العنف الحكومي في تلك المناطق، فإن على الولايات المتحدة أن تقوم بالإجراءات اللازمة للإعلان عن الذهب السوداني والتعامل معه بصورة منفصلة في السوق العالمية، وإخضاعه الى تدابير إضافية. وأضاف أن قيام واشنطن بفرض غرامة باهظة على بنك باريبا الفرنسي (بلغت 8.9 مليارات دولار) لتعامله مع السودان وإيران وكوبا، أدت الى إحجام عدد من بنوك المنطقة عن التعامل المصرفي مع السودان.
كما أن إحدى القضايا التي لا تزال عالقة تخص ما إذا كان يمكن للسودان الاستفادة من تجربته في إنتاج النفط واستخلاص الدروس اللازمة في حال تصاعد إنتاجه من الذهب الذي يمكن أن يعود عليه بالمليارات كما يأمل المسؤولون. إذ تشير التقديرات في عقد الإنتاج النفطي إلى أن السودان حصل على قرابة 60 مليار دولار لم تذهب كلها إلى خزينة الدولة، وإنما ذهب جزء كبير منها إلى الشركات الأجنبية العاملة، وفق اتفاقية قسمة الإنتاج التي يخصص لها ما يُعرف بـ "زيت التكلفة"، لمقابلة ما قامت بإنفاقه في عمليات الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والترحيل. ولهذا يُعتقد أن المبلغ الذي حصلت عليه حكومة السودان من العائدات النفطية يتراوح بين 30 أو 35 مليار دولار، وأن 12 ملياراً منها كانت من نصيب جنوب السودان بعد اتفاقية السلام مع المتمردين في العام 2005. وما تبقَّى أصبح أضخم مبلغ بالعملات الصعبة تحصل عليه أي حكومة سودانية، لكن لم يتم استثماره بصورة جيدة في قطاعات إنتاجية متجددة مثل الزراعة.
والذهب مثل النفط، ثروة ناضبة. وعليه أصبح السؤال المطروح بإلحاح يتعلق بالسياسات التي ستتخذها الحكومة للاستفادة من هذه العائدات المتوقعة، وإلى أي مدى يمكن للوجود الروسي في ميدان الذهب أن يماثل الدور الذي قامت به الصين في الميدان النفطي.
ومع تتالي طوفان الأسئلة المتعلقة بالذهب، لخص أحد المراقبين الوضع باستدعاء ما نُقل عن أحد شيوخ القبائل عندما ظهرت دعوة الثائر محمد أحمد في القرن التاسع عشر (الجد الكبير للزعيم الحالي الصادق المهدي)، معلناً أنه المهدي المنتظر، وعلى الناس مبايعته لتخليص البلاد من الظلم وإقامة العدل. وفي رده على أسئلة أحد أتباعه عن دعوة المهدية تلك، قال الشيخ بلغة سودانية دارجة: "إن كان مهدي جيد لينا، وإن طلع ما مهدي شين لينا"، أي اذا اتضح انه مهدي الله المنتظر فعلاً فهذا جيد لنا ومن حسن حظنا، واذا كان غير ذلك فليس لنا من الأمر شيء لنخسره!
[يعاد نشر المادة ضمن اتفاقية شراكة وتعاون بين "جدلية" و"السفير العربي"]
![[???? ?????? ?.?]](https://kms.jadaliyya.com/Images/357x383xo/sudangold.jpg)